(رام الله 2018)
الخامسة إلا
خمس دقائق عصرا، أجلسُ في ردهة الانتظار، تنتابني مشاعر متضاربة بين الحيرة
والقلق، فهذه أول مرة يستدعيني فيها رئيس التحرير، كان يكتفي بالاتصال الهاتفي
لإبداء ملاحظاته على مقالاتي وتقاريري الصحافية، ولم يسبق له أن طلب مني الكتابة
في موضوع محدد.. ماذا يريد مني يا ترى؟
في الموعد المضروب
تماما طرقتُ باب الغرفة، تقدمت بخطا سريعة، وصافحته.. رحب بي بابتسامة عريضة،
تبادلنا المجاملات التقليدية، وخضنا بشكل سريع في أحوال البلد السياسية
والاقتصادية، كان يتكلم بثقة كعادته، وأنا أترقب بقلق وأتساءل في نفسي: ماذا يريد
مني؟
-
كما تعلم، الشهر القادم ستحل الذكرى السبعون للنكبة، وستكون هنالك فعاليات
عديدة ومتنوعة.. يصمت قليلا، ويشعل سيجارته، ثم يواصل حديثه بنفس النبرة..
-
ستتناول جريدتنا ما يختص بالجانب الثقافي والإنساني، وأريد منك مادة دسمة
تليق بجلال المناسبة.. لا أريد قصة صحافية معروفة، ولا مواضيع مكررة ومطروقة..
قلت له مستغلا
ثواني صمته القليلة، وقد لمعت بذهني فكرة، طالما راودتني: ما رأيك أن أجري مقابلة
مع أحد المسنين الذين عايشوا النكبة، ليسرد لنا بعض الحكايات التي طواها النسيان..
-
فكرة جيدة، ولكن تجنب الطرح التقليدي، فتقريبا لم يبقَ شيئا إلا وتناوله
الكتّابُ والرواة والمحللون السياسيون والمؤرخون.. فكّر خارج الصندوق.. أنا أثق
بك.. وقد اخترتك بالذات..
-
شكرا أستاذ على هذه الثقة، سأبذل جهدي ألا أخيب ظنك..
أسبوع كامل
وأنا أقلّب الأفكار والمقترحات، سألتُ الأصدقاء والأقارب، بحثتُ مطولا في قائمة
المسنين الذين لديهم ما يقولونه، وكلما طُرح اسم يتبين لنا أنه متوفى، أو مريض، أو
مقيم خارج البلاد، أو أنّ ذاكرته غير موثوقة.. حينها شعرت بالخوف من فكرة أن الذين
وُلدوا في البلاد، وعايشوا النكبة على وشك الانقراض.. لم يتبدد خوفي إلا حينما طرح
لي الصديق إسماعيل، وهو قريبي أيضا، اسم الحاج محمد عيسى (أبو أيمن).. عمره يقارب
التسعين عاما، ليس بكامل صحته، لكن ذهنه ما زال متقدا، صحيح إن ذاكرته القصيرة
أصابها الوهن، حتى أنه لا يحفظ أسماء أحفاده، لكن ذاكرته البعيدة بخير، بل
ممتازة.. مشكلته أنه يرفض الكلام.. مستعد أن يحكي لساعات عن ذكرياته في "بيت
القطا"؛ عن محبوبته الأولى، وعن غيرة زوجته وغضبها كلما ذكر اسمها، عن مواسم
الحصيدة، والعونة، والطوابين، وعن شقاوته أيام الطفولة، عن دكانة أبو عطا، والسوق،
ووادي الصرار، وعن الأعراس التي كانت تمتد لأيام، وعن المدرسة التي حوّلها
الإسرائيليون إلى معهد زراعي.. لكنه يتجنب أي حديث عن يوم النكبة بالذات، وعن أيام
الهجرة الأولى.. تشعر وكأنه يخفي سرا ما..
إذا وافق على
مقابلتك، لا تصطحب معك كاميرا، صورة واحدة من هاتفك الذكي تكفي، ولا تشعره أنك صحافي..
دعه يتكلم بانسيابية، فإذا شعرت أنه ارتاح لك، إطرح عليه سؤالين، الأول: لماذا
تفرقت قريتنا على أكثر من سبعة مخيمات؟ خلافا للقرى الثانية التي كان يتركز
أهاليها في مخيم واحد أو اثنين فقط. الثاني: ما هي قصة السبعة أشخاص من ذوي
الإعاقة، الذين بقوا في القرية، ولم يغادروها؟ وماذا حصل معهم؟ ولكن انتبه هذا
السؤال قد يفجّر الجلسة..
بفضول شديد،
وبشكل آلي سألت إسماعيل: ما هي قصة هؤلاء الأشخاص السبعة؟
-
سل الحاج أبو أيمن، فهو الوحيد الذي يعرف الإجابات.. وأنصحك أن تستعجل
اللقاء، فإن مات الرجل مات معه السر وإلى الأبد..
(شعبان 1948)
نادى شعبان
على ابنه بصوت متوسل: بدي أتحمم يابا، صارلي شهرين ما تحممت، حاسس إني عفنت، ومش
طايق ريحتي..
أخفى بسام إحساسه
بالحنق، وحاول كتم غيظه، وأجابه بأدب مفتعل: طيب يابا، هسه بحضرلك المية السخنة
والمنشفة، خرج من الغرفة يعتريه إحساس بالخجل من نفسه.. كيف لم أنتبه له طوال تلك
المدة؟ لا بد أن الله سيعاقبني على إغفالي وإهمالي والدي..
لم يعد شعبان عصبيا ونزقا كما كان قبل نحو عشر
سنوات، أي بعد إصابته بالشلل، صار يميل للهدوء، يمضي وقته صامتا، متأملاً ما حوله،
مستذكرا أيام شبابه وعنفوانه، أو صافنا في أحوال الدنيا وتقلباتها.. لا يتحدث إلا
إذا سأله أحد، فيجيب بأقل الكلمات، وأحيانا يكتفي بهز رأسه..
قبل أن يتم
عامه الأربعين بأسابيع قليلة، وأثناء عمله في مقلع الحجارة في "كفر
حلفا"، تعثرت قدمه، فسقط من جرف بعلو نحو ثلاثة أمتار، ما أدى إلى إصابته
بكسور في أسفل عموده الفقاري، وإصابته بشلل في أطرافه السفلية.. أمضى شهرين في
مستشفى المطلع في القدس، لم تكن الأصعب في حياته، فقد كان حينها يعتريه أمل غامض
بأنه سيتعافى ويمشي من جديد، ولكنه بعد أن فقد ذلك الأمل، صار عصبيا على نحو لا
يطاق، دائم الصراخ، يشكُّ في كل من حوله، يعترض على كل شيء، متجهم وفي داخله بركان
غضب، يثور لأتفه الأسباب.. بيد أنه في غضون سنة أو أكثر قليلا بدأ يستسلم لحالته
الجديدة، ويتكيف معها، وأخذ غضبه يخفت تدريجيا، وقلت عصبيته، وحل محلها نوع من
الرضا والقبول، يردد دائما "رضيت بما قسمه لي الله".. ربما كانت وفاة
زوجته رقية سببا في هذا التحول، فهي الوحيدة التي كانت تتحمله، وتمتص غضبه، وتتلقى
توبيخاته صابرة، أو مرغمة، بعد رحيلها صار عليه التكيف من جديد مع مرضه وأحزانه ووحدته..
خلال تلك
السنين كبر شعبان سريعا، حتى بان بعمر الثمانين، ضمرت عضلاته، وفقد ثلث وزنه، وتكورت
عيناه في محجريهما، وبانت عظام وجنتيه، وصار قليل الكلام، لا يطلب شيئا من أحد،
حتى شربة الماء، مكتفيا بوجبة واحدة، أو وجبتين طوال اليوم، وظل ابنه بسّام وابنته
سميّة يقومان بواجبهما تجاهه بما يرضي ضميريهما، يتناوبان على خدمته، تأتي سمية
يومين في الأسبوع، وهذا أقصى ما سمح لها زوجها به، بينما يتولى بسام بقية الأيام؛
يحمله من كرسيه الخشبي إلى فرشته كل مساء، يقلبه مرات عديدة في الليل، يعيده صباحا
إلى كرسيه المثبت في نفس الزاوية على الشرفة، ينقل إليه أخبار البلد والناس.
تأخرت سميّة هذه
المرة شهرين كاملين عن الحضور لخدمة أبيها، لم يلح بسام ولا والده بطلب عودتها،
فهما يعلمان أن ذلك صار يؤثر سلبيا على علاقتها بزوجها، خاصة وأنها رُزقت بطفلة،
وستنشغل بها..
تعمق إحساسه
بالوحدة، فبسام خارج البيت معظم الوقت، إما للعمل، أو لانشغاله مع أصحابه.. وبعد
أن ظل الأقارب والجيران يزورونه في الأعياد وفي شهر رمضان، في آخر سنتين لم يزره
أحد، حتى أيقن أنه بات منسيا، وأن أجله قد دنا..
كان منتصف
العام 1948 مختلفا في كل شيء، لم تعد صباحاته ندية، صارت شاحبة، تنذر بحريق قريب..
منذ بداية العام كان الأهالي قد دفنوا ثمانية شبان، قضوا على يد منظمة
"إشتيرن" الصهيونية، بالإضافة لعشرة شبان آخرين اعتقلتهم سلطات الانتداب
البريطاني.. وشعبان، ما زال ملتحما في كرسيه كأنه قطعة منه..
- يا إبني صار
عمرك عشرين سنة، ولسه ما تزوجت؟ شوفلك بنت حلال، والله نفسي أفرح فيك قبل ما أودع
الدنيا..
- يابا، شو
هالحكي؟ هو حدا فاضي للجيزة هالأيام؟ البلد قايمة قاعدة، والله أعلم شو بده يصير..
- شو بده يصير
يعني؟ اللي كاتبه ربك بصير..
- هيْ معظم
شباب البلد راحوا مع جيش الجهاد، ونفسي أروح معهم، بس خايف أتركك لوحدك.
- روح يا ابني،
ولا يهمك، أنا بدبّر حالي.. بس انت لا بتعرف تطخ، ولا إلك بالبواريد!
يسند بسام
رأسه على كفه صافنا محدقا نحو البعيد، ويسكت عن الكلام كما لو أنه يريد إنهاءه،
فهو يعلم أن دعوة والده للانضمام لجيش عبد القادر الحسيني ليست جدية، فلو تركه
بمفرده سيموت جوعا.. وأثناء ذلك ارتج البيت من دوي انفجار قريب، حتى إنَّ كوب
الشاي سقط من يد شعبان المرتجفة..
-
يا ساتر يا رب.. ألطف فينا يا ألله.. صاح شعبان بصوت خائف..
تناول بسام
خرقة، وأخذ يمسح الشاي المنسكب على رجلي والده.. وهو يقول له بصوت خائف: ملاحظ
يابا إنه القذائف كثرت، وصارت تقرب أكثر، شكلهم ناويين عالبلد.. يجيبه الابن محاولا
طمأنته، وتهدئة مخاوفه: أكيد ناويين، بس الجيوش العربية مش رح تسمحلهم..
-
الله يسمع منك، بس يا ابني إذا هجموا علينا، شو بدك تساوي؟ يعني بتهرب مع
الهاربين؟ ولا بتظلك معي؟ أكيد مش رح تقدر تحملني.. قال جملته الأخيرة وكأنه يعلن
الاستسلام لمصير مجهول..
-
ما بتركك يابا ولو شو ما صار..
-
بس هاي حرب، والحرب بتحوّل الناس لوحوش ومجرمين، والخوف بعمل كل شي.. أكثر
مما تتوقع..
-
توكل على الله يابا..
-
بس المهم تدير بالك على أختك وأولادها.. جوزها هامل، ما تركن عليه..
-
ولا يهمك يابا.. بصير خير..
-
جاي على بال حبة تين..
-
حبة تين؟!
-
آه يابا، نفسي في حبة تين..
-
والله يابا إنك فاضي أشغال.. الناس في إيش وانت في إيش؟
(البيرة 2018)
في أحد أحياء
البيرة الهادئة، قبالة منزل حجري مكون من طابقين، أمامه حديقة واسعة منسقة بعناية،
وساحة مبلطة مُهدت في ظل دالية ضخمة، ذات قطوف دانية، نزلنا من السيارة، أنا وأصدقائي
عماد وصالح وممدوح، وهم من الشبان المهتمين بتوثيق الذاكرة الشفوية، كان بانتظارنا
الدكتور أيمن، دكتوراه في القانون، خريج النمسا، وبجانبه شقيقته الطبيبة بيسان..
رحبا بنا، وأوصلانا إلى ردهة الضيوف، حيث كان الحاج أبو أيمن بانتظارنا، متكئا في
صدر الجلسة، يدخن سيجارته بهدوء، وقد بدا وقورا، بلحية بيضاء مشذبة، ولكن أصغر مما
توقعت، شديد الاهتمام بمظهره وأناقته..
مضت ساعتان
على حديث أبو أيمن الشيق عن بيت القطا، وحكاياته عن البلاد، والتي لم تخلُ من بعض
النكات.. كان يتحدث بطلاقة مدهشة، مستحضرا ذكرياته البعيدة بأدق التفاصيل: عن
أبناء جيله الذين رحلوا واحدا تلو الآخر، عن شيخ الجامع الذي كان ينام أثناء
الصلاة، وعن الراديو الذي جلبه سمعان من دمشق لمقهاه، وعن الأستاذ هشام الذي كان
يقرأ الجريدة أمام جمهرة من الحاضرين كل خميس بعد عودته من القدس، وعن الجنود
الصهاينة الستة الذي قُتلوا في كمين نصبه لهم الثوار قبالة المدرسة، عن الصبايا
وجرار الماء، عن الثلجة الكبيرة، حتى إنه عاد بذكرياته إلى أيام الأتراك، والجوع،
وسفر برلك..
مع أن
الدكتورة بيسان طلبت منا بأدب جم ألا نثقل عليه بالأسئلة، وألا نطيل السهر لأن
صحته لا تحتمل، إلا أننا نسينا كل شيء، حتى الدكتورة نفسها كانت تزيل فناجين
القهوة، وتحضر بدلا منها أكواب الشاي، فعلتها مرتين، وكان واضحا أنها وشقيقها أيمن
مهتمان بتلك القصص، وكأنهما يسمعان بها لأول مرة، أو هكذا تهيأ لي.. حينها شعرت
بأن الحاج أبو أيمن قد ارتاح لنا، وأن سيل ذكرياته قد تدفق دفعة واحدة، وأنه يرغب بمزيد
من الكلام.. ومع أني كنت قد حضّرت صيغة السؤال، وتدربت عليه كثيرا، إلا أنني بقيت
مترددا، حتى استجمعت شجاعتي وسألته بصوت مرتبك:
-
ليش يا حاج أهل بلدنا، توزعوا على سبع مخيمات؟
سكت الحاج
لبرهة، ورمقني بنظرة كالصقر، لم يبدد خوفي منها سوى ابتسامته الهادئة، وسؤاله لي بنبرة
حاسمة: في عندك سؤال ثاني براسك، وخايف تسأل؟
أدركت أنه كان
متوقعا سؤالي، فاستجمعت بعض رباطة جأشي، وقلت له: نعم، بدي اسألك عن سبعة أشخاص
كانوا ذوي إعاقة، وتركتوهم في البلد.. صحيح هالحكي، أم هي مجرد إشاعة؟ وإذا صحيح،
شو صار معهم؟ رميت سؤالي كما لو أني أرمي قنبلة يدوية وقد انبطحت أرضا تفاديا
لشظاياها..
يصمت الحاج أبو
أيمن، ويسود سكون مريب لنصف دقيقة أو أكثر.. وعيوننا مركزة عليه بقلق وترقب، وهو
ممسك بلحيته البيضاء ويجرها بلطف، ويجيب بنبرة الحكماء:
-
شوف يا إبني.. السؤالين مرتبطين ببعض، وإجابتهم واحدة..
يتناول فنجان
قهوته، ويشرب آخر جرعة فيها، ثم يعدل جلسته، ويجر تنهيدة عميقة، قائلا:
-
بتعرف، هاي أول مرة بدي أحكي في الموضوع، ميت مرة سألوني عنه، وكنت دائما
أتجنب الإجابة.. حاسس إنه في صخرة كاتمة على صدري، وخايف أموت وتظل الصخرة فوق
قبري.. لازم أحكي وأريح ضميري.. لازم أحكي وأمري لله..
يجر نفسا
عميقا، مطلقاً زفرة حادة، كما لو أنه سيخرج نارا مستعرة.. يحدقنا جميعا بنظرات
متتابعة تحمل ألف معنى، ثم يقول بصوت مستكين: أنا حجيت مرتين، وتعلقت بأذيال
الكعبة ورجوت الله أن يصفح عني، دعوته من كل قلبي، متضرعا نادما.. وهناك بين الصفا
والمروة كان الناس يهللون ويكبّرون، وكنت أنا مشغولا بهم، أنادي عليهم واحدا
واحدا: سامحونا.. سامحونا، قصرنا بحقكم، لم يكن باليد حيلة. ثم أرفع يدي للسماء
باكيا: نحن بشر يا ألله، بشر ضعاف، نجبن، ونخاف، ونتصرف بأنانية..
ترمقني
الدكتورة بيسان بنظرات عتاب وخوف، وكأنها تقول: ألم أقل لكم لا تثقلوا عليه
بالأسئلة؟ شعرتُ حينها بتأنيب الضمير، فلم أكن أتوقع أنه سيتأثر إلى هذه الدرجة
بذكريات تعود لأكثر من سبعين سنة.. ولكن لحسن طالعي، استعاد الحاج أبو أيمن هدوءه،
وبدا مستعدا للبوح بالسر الكبير..
-
أولاً، هم مش سبعة.. هم 11، طفل كان بحدود العاشرة من عمره اسمه سمير، كان
يعاني من شلل دماغي، وامرأة واحدة، كان اسمها أم سميح، وتسع رجال، منهم سيدي عبد
الرحمن، وابن خالتي شعبان، وكلهم ختيارية، ومقعدين، ومرضى..
شعر الحاج أبو
أيمن بأن الصخرة التي على صدره بدأت تتزحزح، وما عليه سوى مواصلة الكلام.. لم يعد
هناك ما يمنع، بل المطلوب منه مزيدا من التوضيح، وسرد الحكاية بعناية وصدق.. ومن
أولها..
-
يا جماعة، لازم تفكروا منيح، وتتذكروا كيف كانت ظروفنا في ذلك الوقت
العصيب، تخيلوها بس بأمانة.. كنا أميين، في كل البلد اللي بعرفوا القراءة والكتابة
معدودين عالأصابع، كنا فقراء، وبسيطين، وخايفين.. هو اللي صار في دير ياسين قليل؟؟
بالرغم من
اهتمامي الشديد بمعرفة تفاصيل القصة، إلا إني كنت خائفا على الحاج، فحاولت ألا أحدق
بعينيه مباشرة، وأن أتركه على راحته ليواصل السرد، وفي نفس الوقت أتابع لغة جسده
التي كانت تشي بوضوح أنه منفعل، ومتأثر، ومتردد في سرد بعض التفاصيل، إما أنه يشعر
بالحرج، أو بالندم، أو يخشى فضح أناس معينين.. كان عليّ أن أتابع بصمت..
-
ما كان عنا مستشفيات زي الأوادم، ولا كنا نعرف العربات الخاصة بالمشلولين،
اللي بعجلات يعني، ولا في شوارع مزفتة، كان لازم نطلع الجبال والوديان، طرق كلها
وعر ومطبات، وصخور وحجار وحبايل.. يا دوب الشاب القوي يعرف يمشي فيها.. كانت كل
عيلة حاملة طناجرها، ولحافاتها، وأغراضها، وأولادهم الصغار.. والطخ فوق روسنا، كنا
بنفكر يومين ثلاثة وبنرجع..
يعدل الحاج
جلسته، ويشعل سيجارة جديدة، ثم يحدق بي مباشرة. فلاحظت أنه يحاول كتم اهتزاز ركبته
اليمنى..
-
بعد ما سمعنا اللي صار في دير ياسين، حسينا إنه الدور الجاي علينا، وما
بخفيك، كنا خايفين ومرعوبين، خايفين على نسوانّا، وبناتنا، وصغارنا.. خايفين يهدوا
البيوت فوق روسنا.. معظم أهالي البلد هربوا، في ليلة ما فيها ضو قمر، حملوا اللي
بيقدروا عليه، وأخذوا أطفالهم واتجهوا شرقا.. إحنا ظلينا صامدين شهرين بعدها،
حوالي ميت عيلة، أو أكثر شوية، ظلينا حتى شهر تموز.. كان وقتها شهر رمضان، وفي
ثاني يوم من الصبح شفنا أهالي دير حلفا جايين علينا، مذعورين، تطلّع في وجوههم فتشعر
إنه القيامة قامت، خلال دقائق انتقلت عدوى الخوف بين الناس.. تجمعنا العصر في
السوق قبال الجامع، بعض المتعلمين قالوا ما حدا يطلع، ويا ريتنا ردينا عليهم..
صارت فوضى شديدة، الكل بصرخ، والأولاد بيعيطوا، والنسوان ندب ونواح.. وصارت
القذائف تنهمر علينا كل دقيقة تقريبا، استمر القصف طول الليل، كل عيلة هربت
لبيتها، وأخذوا بعض حاجياتهم، وقبل طلوع الشمس ما ضل حدا في البلد..
بدأ صوت الحاج
يتغير، وصار يتلعثم في الكلام، صارت نبرته ممزوجة بالأسى والحنين، شعرتُ أنه يهم
بالصراخ، أو على وشك البكاء، وكأنّ الذكريات فتحت جرحا قديما، وأنه يريد التوقف
هنا، وإنهاء القصة عند هذا الحد.. قبل أن نعرف مصير الطفل والمسنّين العشرة، الذين
تركهم الأهالي وراءهم.. احترمنا صمته، وبقينا منتظرين لدقيقة أو أكثر.. تناول
الحاج كوب ماء، وشربه دفعة واحدة..
-
قبل الظهيرة، كنا قد وصلنا رنتيس، والبعض وصل شقبا ونعلين.. جلسنا لنستريح بين
أشجار الزيتون، كان الجو حارا جدا، وطول الوقت وريقي ناشف زي الحطبة، بعضنا أفطر
من شدة العطش، أو احتجاجا على المهانة والخذلان، وتعبيرا عن السخط.. تفقدنا بعضنا
بعضا فاكتشفنا أننا من هول الفاجعة قد نسينا أعزاءنا وراءنا.. وفي الحقيقة لم
ننساهم، لقد خذلناهم.. ينهي جملته الأخيرة، ويبلع ريقه، ثم يمسح دمعة انسكبت من
عينه..
ارتبكنا جميعا،
وبقينا صامتين، متعاطفين مع مشاعره، وفي داخل كل واحد منا رغبة لسماع بقية التفاصيل،
انتظرت برهة، ثم سألته بفضول واستغراب وبصوت خفيض: وكيف حصل ذلك؟
-
ما حصل مع سيدي عبد الرحمن، حصل مع العشرة الآخرين، وبالذات مع شعبان اللي
كنت متابع مأساته عن قرب.. وبقدر أتخيل كيف كانت مشاعر الناس وقتها، تحت دوي القصف
المتواصل، ومع انتشار الشائعات، ارتبكنا، فقدنا عقلنا، لم نعد نميز الصح من
الخطأ.. كانت ليلة رهيبة، عتمة، وخوف واحنا ملزقين ببعض، قال أبي رحمه الله بكره من
الصبح نخرج كلنا، نأخذ الأشياء المهمة فقط، كل شخص كبير يحمل طفلا صغيرا، وما
يستطيع حمله من متاع.. نبيت ليلة في رنتيس، وفي اليوم التالي سأعود لأخذ والدي،
سأحضر عربة أو دابة..
يبلع الحاج
ريقه، فتناوله ابنته على الفور كأس الماء، شكرها، ونظر إلينا فبدت عيناه محمرتين
كالجمر، كما لو أنه يريد التبرير، أو التوضيح، أو الاعتذار، قائلا: رجل بوزن سيدي
حتى لو تمكن أحد من حمله على ظهره، لن يستطيع السير به أكثر من عشرين خطوة..
صار صوته متحشرجا،
مخنوقاً، صمت لبرهة، وتناول كوبا آخر من الماء، ثم قال: تركنا بعض الطعام، وجرة مي
بجوار سيدي، وودعناه بدموع ساخنة، وقد أقسم له والدي أنه سيعود بأسرع وقت، وأنه لن
يتركه.. ظل صامتا بشكل مريب وقاتل، عيناه فيهما الرجاء والتوسل، ودمعة محتبسة، وألف
كلمة.. لكنه لم ينبس بحرف..
يقوم الحاج
أبو أيمن عن مقعده، يغيب لدقائق معدودة، ونحن صامتون تماما، وكأننا نشاهد فيلما
دراميا، نترقب نهايته بلهفة.. أظنه توارى عنا ليجهش في البكاء، يعود لمقعده،
مستأنفا حديثه ولكن هذه المرة بنبرة تقريرية: أنتم تعرفون قصة الهجرة، كل العالم
يعرفها بتفاصيلها، لكن ما لا تعرفونه أن المؤامرة كانت جاهزة، أطبقت علينا من جميع
الجهات، الجيوش العربية انسحبت قبلنا، وكالة الغوث كانت بانتظارنا وخيمها جاهزة،
الصهاينة بعد ما طلعنا من البلد مباشرة زرعوا الأسلاك الشائكة، ووضعوا القناصة في
كل مكان.. صارت العودة للقرية مغامرة مميتة..
لمعت عينا
الحاج، واتسعت حدقتاه، وهو يواصل حديثه، ولكن هذه المرة بنبرة فيها فخر، وفيها
أسى..
-
ومع ذلك رجعت بطلب من أبي مع عشرة من الشباب إلى البلد، بحثنا عن أقربائنا،
أحضرنا لهم طعاما.. أذكر تماما جاري وقريبي بسام الشعبان، ظل مواظبا على تفقد
والده أكثر من أسبوع، كان يأتي بمفرده كل يوم حاملا معه دلو تين، حتى وجدناه مقتولا
قرب سنسلة، كان رأسه مهشما، توجهنا إلى بيته فوجدنا أباه مقتولا أيضا.. شعرنا بالغضب
والحزن، ولكن في الوقت نفسه شعرنا بالخوف، انسحبنا على الفور، وفي الليل رجعنا
ودفنا الاثنين في قبر واحد.. بعد استشهاد بسام وأبوه، لم يعد أحد يجرؤ على العودة
لمدة ثلاثة أيام.. في اليوم الرابع رجعت مع ابن عمي أمجد، لم نجد أي أحد.. فتشنا
كل البيوت، والجامع، والمعصرة، والمطحنة، والمدرسة، والحقول المجاورة.. كانوا قد
اختفوا تماما.. لم نعثر حتى على جثة، أو آثار دم، كأنما انشقت الأرض وابتلعتهم..
-
لم يصدق أحد قصة اختفائهم.. شعرنا حينها بالخيبة، وبمرارة الهزيمة، بدأنا
ندرك أن المأساة أكبر بكثير مما توقعنا.. رحنا على أكبر ضابط في جيش الإنقاذ،
وعدنا أن يقوم باللازم، ورجعناله اليوم الثاني، وقال إنه بعث برقية للأمم المتحدة
والصليب الأحمر، وجامعة الدول العربية.. وهاظ يوم وهظاك يوم.. عالفاضي..
-
طيب شو عملتوا؟
-
قررت كل عائلة أن تتجه إلى مكان مختلف، أظن أن إحساسنا بالخزي هو ما كان
يجمعنا، لم نتحمل نظرات بعضنا لبعض، أردنا أن نتخلص من هذا العار.. بتواطؤ ضمني.. لذلك
همنا على وجوهنا، محاولين الابتعاد أكبر مسافة ممكنة عن تلك الذكرى الأليمة، ربما
أردنا أن ننسى من نسيناهم.. لذلك تفرقنا في كل الاتجاهات.. في الأمعري، والجلزون،
ودير عمار، وبير زيت، ورام الله، حتى وصلنا الوحدات والزرقاء في الأردن.. هناك لن
يسألنا أحد أين جدكم المقعد؟ وين ستكم الحنونة؟ ولن تعرف كل عائلة ما حل بالعائلات
الأخرى.. وهكذا طوينا القصة بمأساتها..
-
ولكن، فعلا سؤال محير، وين اختفوا؟
-
بعد فترة بسيطة وكّلنا محامي يهودي ليعرف مصيرهم، دفعناله مبلغ كبير، قلنا
له بس بدنا نعرف شو صار معهم؟! إذا عايشين رجعولنا إياهم، وإذا ميتين خلونا نصلي
عليهم، وندفنهم على الأقل.. رجع بعد شهر وقال إن الحكومة الإسرائيلية بالفعل وجدت
عشرة مسنين من ذوي الإعاقة، وأخذتهم إلى مأوى للعجزة، ورفض يحكي اسم المأوى.. طبعا
إحنا ما صدقناه، رغم أنه أحضر مجلة أمريكية فيها صورهم، وفيها تفاصيل الخبر..
ولكن، اللي قتلوا النسوان والأطفال في دير ياسين وقبية والطنطورة بدهم يشفقوا على
شوية ختيارية!! أكيد قتلوهم، ودفنوهم في قبر جماعي، أو رموهم في بير.. يمكن الطفل
الصغير أخذوه، ويمكن لا.. ما حدا بعرف.. اللي بعرفه عالأكيد إني عشت كل هذي السنين
وأنا بتعذب، كل يوم بشوفهم، كل ليلة بحكي معهم، بتذكر عيونهم الحزينة والمرتعبة، وهي
تترجانا ما نتركهم، وما نطلع من البلد.. ويا ريتنا ردينا عليهم..
مرت أربع سنوات بعد تلك الليلة الكئيبة التي سمعت بها قصة المنسيين الأحد
عشر، ويبدو أن عدوى عذاب الضمير قد انتقلت لي، بعد أن توفى الحاج أبو أيمن.. الذي
ظل حتى آخر يوم في حياته يتساءل بحيرة ومرارة إذا كان المنسيون قد سامحوه، وأنا
أتساءل إن كان قد سامح نفسه أم لا.. المهم أنه رحل بعد أن قصَّ حكايته أخيرا، وأزاح
تلك الصخرة عن صدره، لكنه نقلها إلى صدري..
لم أنشر قصة المنسييّن بعد.. ولا
أعرف إذا كنتُ سأنشرها يوما ما..
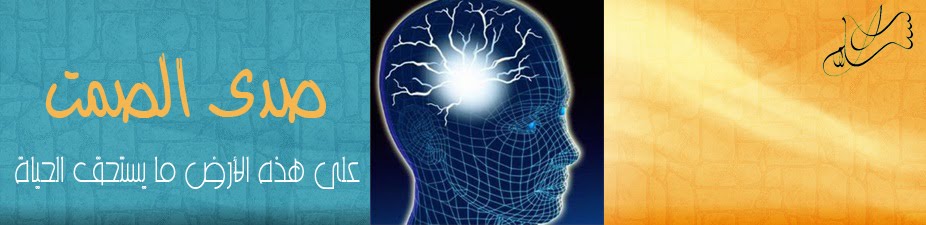
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق