لا حاجة هنا
للغوص عميقا في تاريخ الحركات الثورية، ومبررات وجودها، لنبدأ بخمسينيات القرن
الماضي، حيث شهد العالم اندلاع العديد من الثورات، في عموم أمريكا اللاتينية
وأفريقيا وشرق آسيا، والتي تردد صداها في المنطقة العربية.. كانت أغلب تلك الثورات
في مواجهة المستعمر ومن أجل الحرية والاستقلال..
شهدت البلدان
العربية، سواء التي تحررت بثورات شعبية، أم تلك التي نالت استقلالها كنتاج للحرب
العالمية الثانية مرحلة سياسية سميت بالمد الثوري، والذي تصدرته الحركات القومية
واليسارية.. وكانت مطالبها تتلخص في الاشتراكية والعدالة الاجتماعية والكرامة
والحريات العامة وحقوق المواطنة..
ما يجمع تلك
الثورات (الأممية والعربية) سمتان، الأولى: أنَّ مطالبها وأهدافها محقة وعادلة
ومشروعة، وهذا الذي تأسست عليه شرعياتها، وبها نالت حضورها الجماهيري.. الثانية:
أنها لجأت إلى أسلوب العنف الثوري، سواء في مواجهة قوى الاستعمار، أم لمواجهة نظم
الاستبداد والفساد.. وما يبرر "عنفها" قسوة وضراوة المستعمر المحتل،
الذي لم يكتفِ بنهب الخيرات والموارد، بل عمد إلى استعباد الشعوب بأبشع وأفظع
الجرائم وأكثرها وحشية.. وأيضا قسوة وتسلط النظم الديكتاتورية، التي قمعت شعوبها
وزجت بهم في السجون، وامتهنت كرامة الناس، واحتكرت السلطة، واستأثرت بخيرات
البلاد..
وقبل أن نستكشف
ما حدث لتلك الثورات فيما بعد، لنضيف إليها الحركات الثورية الإسلامية؛ أي
الجماعات الجهادية والتي شهدت بداية الثمانينيات انطلاقتها وانتشارها في ربوع
العالم، لنتعرف بعد ذلك على السمات الإضافية التي تجمعها كلها.
قبل عام 1980
كان عدد المنظمات الجهادية لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وخلال عقد الثمانينات
تضاعف العدد ثلاثة مرات، ومع أواسط التسعينات نما العدد إلى نحو ستة وعشرون، وفي العقدين
الماضيين صار العدد بالعشرات.
بدأت
تلك الجماعات كحركات سياسية اجتماعية تعاني القهر، وتكابد الظلم، وتبحث عن فرصتها
في التعبير عن ذاتها.. ولكن مع إضطهادها، وخنق صوتها، وعجزها عن تحقيق أهدافها
بالطرق السلمية، ومع تفشي الإستبداد والقمع السلطوي، وتوالي الهزائم والإنكسارات، تولّدَ
العنف المضاد، واكتملت دورة العنف السياسي؛ فبذرة العنف بدأت في أحضان النظم
الاستبدادية، وأحيانا بتشجيع منها، ونَمَتْ مع الخيبات والهزائم، وكبرت مع الأزمات
السياسية والاجتماعية، وقد رعتها دول وجماعات وقيادات تحمل مشروعا أمميا صار يعرف
باسم مشروع الإسلام السياسي.
ما يجمع الجماعات الجهادية مع القوى
الثورية العلمانية والقومية أنها كانت مراحلها
الأولى نقية، وطاهرة.. القوى القومية والعلمانية التي تسلمت السلطة تحولت إلى نظم
بوليسية قمعية، وعمَّ فيها الفساد، وأفقرت بلدانها، وفشلت في تقديم أي نموذج رشيد للحكم..
وهذا ما حدث أيضا للجماعات الجهادية، سواء استلمت دولة، أو سيطرت على منطقة، غرقت
في منظومة العنف والتسلط والفساد، وتوجه عنفها إلى الداخل.. وفي الحالتين كل
الشعارات والأهداف والقيم العليا التي رُفعت في البدايات بقيت في حدود الخطابة وتم
التخلي عنها، وصارت وسيلة وغطاء لفرض السيطرة على الناس بالتهديد والتخوين
والتكفير.. وتبين سريعا مدى هشاشة تلك الشعارات في أول امتحان عملي لها، ذلك لأنها
كانت
دوغمائية وعمومية وسطحية وضبابية، ولا تتضمن تفصيلات ولا آليات عمل، ولا ترتكز على
أسس علمية وعملية.
أما التحول إلى الديكتاتورية، فلأنها
ما أن تفرض سلطتها على بقعة ما حتى تبدأ بتكوين طبقة حاكمة (على الأغلب
أوليغارشية)، ويصبح لهذه الطبقة مصالح خاصة، وامتيازات، ويصبح همها الأساس البقاء
في السلطة، وحماية مصالحها.
أما أتباع تلك
الحركات (بشقيها العلماني والديني) فقد كانوا عقائديين متزمتين،
أو مثاليين طوباويين يحملون مشروعا خياليا في معالمه الأساسية والعامة، أو مغفلون ضلّلوا
الطريق، أو متسرعون لتحقيق أهدافهم السياسية والاجتماعية، أو مندفعون للحد الأقصى بردود
أفعالهم على عنف الدولة وعلى الظلم الموجه ضدهم، وهم في نفس الوقت مغامرون تراودهم
أحلام النصر السريع، وقد ضمت أشخاصا مكبوتين، ومقهورين، وآخرون مصابون بداء الإغتراب،
وعصابيون لم يستطيعوا التعايش مع واقعهم والانسجام مع خط الحضارة المتصاعد.
لكن أخطر ما ميزها هو ازدراء مكانة
الإنسان؛ فهي لا تتنكر لقيم المواطنة وحقوق الإنسان وحسب (بالممارسة الفعلية)، بل
هي في الأساس تنظر للإنسان بصفته مجرد أداة لخدمة أهداف الثورة أو الجماعة،
وبالتالي لا قيمة لحياته، ولا لكرامته، ولا لمستقبله، هو منذور للموت (فداء الوطن،
والثورة، والمقاومة، والزعيم، والدين..)، هو وقود للحروب، ومن واجبه التضحية بنفسه
وبأولاده وبمستقبله.. وتحت هذه الشعارات تم سحق الناس، وتحطيم آدميتهم، وأحلامهم،
واقتيادهم للمعارك وللمغامرات العسكرية.
في العقود الماضية تراجع حضور الحركات القومية والعلمانية، وكادت أن تختفي،
وبقيت الجماعات الإسلامية متصدرة الساحة العربية والدولية، وهنا يمكن القول أنه
بالإضافة للسمات التي أشرنا إليها (التي يشترك فيها الجميع تقريبا)، ثمة سمات أخرى
خاصة بجماعات الإسلام السياسي، وهي:
تتبنى
فكرا سلفيا متزمتا، وترفض فكرة الحداثة والدولة المدنية، ولا تقر بالديمقراطية والتعددية
وتعتبرها بضاعة غربية، وتعادي كل ما له علاقة بالتنوير والتقدمية من أفكار وفلسفات
وفنون وآداب، وتصادر الحريات الخاصة والعامة.
وهذه القوى في
حقيقتها تمثل مشاريع تفكيكية للدولة الوطنية المعاصرة؛ فهي لا تؤمن بالأوطان، ولا
تعترف بالحدود، ولا بالأعراف والقوانين الدولية (إلا بالقدر الذي يحقق مصالحها)،
الوطن بالنسبة بها "مسواك"، والعَلم مجرد خرقة بالية، والولاء للدين (أو
للجماعة بتعبير أدق)، والانتماء للأيديولوجية الحزبية. ولديها مشروع أممي يتجاوز
حدود الجغرافيا والقارات، ويقوم فكر هذا المشروع على مبدأ الولاء والبراء ومعاداة
كل ما لا يشبهها، والتصادم مع كل من يختلف معها.
الهدف الحقيقي
لمعظمها هو الوصول للسلطة، إما بالإنقلاب، أو العمل الدعوي السلمي، أو بالعنف
والتفجير، والسلطة التي يسعون لها ستكون في النهاية حكما ثيوقراطيا استبداديا ليس
فيه مكانة لحرية الرأي، ولا حق الاختلاف، ولا للتعددية وتداول السلطة.
في شعاراتها
وخطابها الإعلامي جمعت بين "الدين"، و"فلسطين"، وبهذا الجمع
نالت الحسنيين، واستحوذت على قلوب الجماهير، وجسدت هذا الجمع بمصطلحات
"المقاومة"، و"محور المقاومة".. ولم تعد المقاومة أداة ووسيلة
بل صارت الهدف بحد ذاته، ومبرر ووجودها، ومنه تستمد شرعيتها وشعبيتها، لذا لجأت إلى
تقديس المقاومة، وتحريم نقدها، أو مساءلتها، وجعلتها فوق كل القيم والاعتبارات. وباسم
المقاومة حولت عنفها الثوري الذي كان موجها للعدو إلى المجتمع نفسه..
هذا ما حدث
مؤخرا في غزة، واليمن، ولبنان، وسورية، والعراق، وأفغانستان، وسيناء، وليبيا،
والصومال، وكل منطقة سيطروا عليها باسم الدين، وباسم المقاومة.
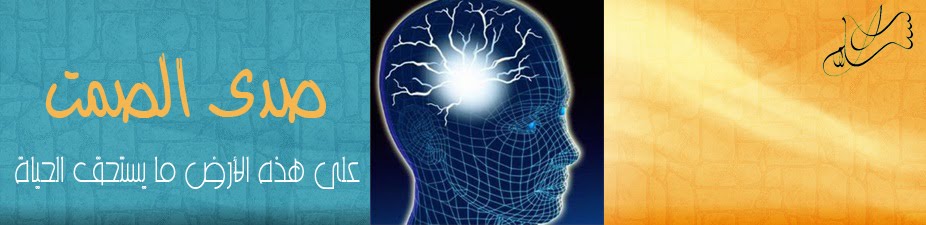
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق