بداية، لا بد من التأكيد على أن هذا المقال لا يناقش مسألة
وجود الخالق، التي أعتبرها محسومة، بل هو نقاش في مسائل الكون والحياة، بين
التصورات الإيمانية التي تعاملت مع الموضوع بالغيبيات من جهة، والتصورات العلمية
والفلسفة المادية من جهة ثانية.. فهذه القضية شكلت المادة الأساسية لكل الفلسفات
الإنسانية، وظلت محورا لكل الأيديولوجيات المتصارعة التي حاولت التصدي لها على مر
العصور، والتي رغم ذلك؛ بقيت لغزا محيرا.
لفترات طويلة احتكرت الفلسفة المثالية قصة الخلق والكون ونشوء
الحياة؛ ومع تطور الحضارة انحسرت الأسطورة وتراجعت الغيبيات لصالح النظريات
العلمية، لكن تلك النظريات العلمية بدت أحيانا مثقلة بالتناقضات والاستحالات، وتعتريها
بعض الثغرات القاتلة، الأمر الذي كان يسمح بتقدم الفلسفة المثالية وأحيانا
الخرافات لتملأ تلك الثغرات، ولكن تقدم العلوم في كل مرحلة كان يجيب على الأسئلة
المحيرة، ويبدد بعض الغموض.
بعض المؤمنين أظهروا تعصبا وتمترسا حول ما يعتقدون به، وهذا حجب عنهم رؤية
الكثير من الحقائق البديهية؛ فهم يبصرون بعينٍ واحدةٍ فقط؛ العين التي تؤمن بحصر
العقل والمعرفة بما جاء في الكتب السماوية، وفي المقابل بعض
العلماء الطبيعيين أظهروا حماسة في الدفاع عن وجهة النظر المادية تفوح منها رائحة
ما يسمى بالأصولية العلمية، أو العقلانية اللامعقولة، التي غطت على رؤية الجوانب
الروحية للمادة. وكأنَّ الوجود لا يرى إلا بعينٍ واحدةٍ فقط، هي عين الإلحاد!
الشيء الجديد الذي اقترحه العلم، هو إعادة سرد حكاية الكون من
أولها، بنظرية الانفجار العظيم، وانبثاق الحياة من المادة، وتطورها المدهش عبر
سلسلة طويلة جدا من التعقيد. وهذا الفتح الثوري الجديد سيزعج –بلا شك– أصحاب
اليقينيات القديمة، وسيحرمهم من سلاح الأحكام المسبقة والنظريات الجاهزة.
فعندما أكد "غاليليو" أن الأرض كروية، أُتهِم
بالهرطقة، وحُكم عليه بالسجن الإجباري في داخل منـزله إلى يوم وفاته، وعندما قال
"داروين" أن للإنسان والقرد جدٌّ مشترك انفتحت عليه أبواب جهنم، وعندما
قابلته سيدة أرستقراطية طلبت منه أن يخفي نظريته وأن لا يعلنها على الملأ، لأنها
فضيحة شخصية.. ولكن الأوان كان قد فات؛ فقد أجبر العلمُ الإنسانَ أن يبتلع الإهانة
ويتنازل عن كبريائه المزعوم بأنه محور الكون، وأن الكون خُلق لخدمته. إذْ أثبت
العلم أن الأرض بأكملها مجرد نقطة تكاد لا تذكر في الفضاء الفسيح.
عندما سأل المشكّكون بوجود خالق لهذا الكون: ماذا كان يفعل
الله قبل أن يخلق السماء والأرض؟ أجابهم المؤمنون الأوائل: بأنه كان يعد الجحيم
لمن يطرح هذا السؤال المحرم. اليوم تدفَّق سيلُ الأسئلة، وتعددت الإجابات على نحو
مربك، بعضها تتلاقى مع الموروث الثقافي والفلسفي، وبعضها تتعارض معه؛ فالعلم
والمعتقد لا يعملان في نفس المجال؛ العلم يتعلم، أما الدين فيُعَلِّم. العلم يشك
ويطرح أسئلة، والدين يقدم إجابات مطلقة وثابتة. العلم يقوّض عالم السكون واليقين،
والدين يريح النفس من عذابات الأسئلة. العلم يحاول فهم الحياة، والدين يعطي لها
دورا وظيفيا ومعنى روحيا.
العلماء أفنوا حيواتهم في البحث والتقصي؛ في المختبرات، وفي
تجاويف الكهوف، وفي أعماق البحار، وعلى فوهات البراكين.. وسواء كانوا ينظرون في
الميكروسكوب لفحص أدق الكائنات، أم كانوا ينظرون في التلسكوب لمراقبة أعظم
المجرات، فإنهم في الحالتين يحاولون الإجابة على نفس الأسئلة، كيف جاء هذا الكون؟
وكيف يعمل؟ وحتى نجيب على هذه الأسئلة، من المهم أن نتملك الشجاعة الكافية
للتساؤل، والتفكير الهادئ غير المتشنج في الإجابة، دون أن نستخدم القوالب الفكرية
الجاهزة، فلا أحد يحق له أن يزعم امتلاك الحقيقة. ولا أحد يملك حق تحريم السؤال.
فإذا حُرّم
السؤال فقدنا الفضول، وبالتالي خسرنا القدرة على الاندهاش؛ لأن من لا يندهش لا
يسأل؛ الدهشة ليست فقط الاستغراب، إنما هي استفزاز العقل ليتحسس المشاهد الوجودية،
ليفكر بها، محاولاً فك طلامسها وألغازها، والسبر في أغوارها، وهذه ليست رفاهية
فكرية، بل هي تطويرا للعقل والفكر والوعي البشرى, فالدهشة هي المحرك الحقيقي الذي
يحث العقل على التفكير، وهي البديل عن لجوء الإنسان القديم إلى حلول سطحية ساذجة
انطلقت من حدوده المعرفية الضيقة للحصول على إجابات سريعة سهلة تريح عقله المُرهق.
من لا يندهش لا يتطور، وبالتالي سيبقى مدفونا في جهله، مكتفيا بإجابات منقولة
معلبة من خزانة الأجداد الزاخرة بالوهم والخرافة.
يحتاج بعضنا أحيانا
أن يصدق الخرافات والمعجزات، ربما لأنهم بحاجة ماسة لشيء ما يهزهم، ويخرجهم من
حالة الرتابة والملل، أو ما يمنحهم بعض اليقين والطمأنينة، وما يعفيهم من مشقة
السؤال.
والمشكلة التي طالما واجهتها البشرية، تكمن في ذلك
الضعف الإنساني أمام الخرافات، أو أمام الكذبات الكبيرة؛ فالناس غالبا يستطيعون
بسهولة دحض الكذبة الصغيرة، حتى لو كانت متقنة، أما الكذبة الكبيرة، والكذبة
المتواصلة، فهم يميلون لتصديقها، من منطلق أنه هل يُعقل وجود كذبة بهذا الحجم؟! هل
يعقل أن يكون أسلافنا على هذا القدر من السذاجة؟ هل يعقل أن تكذب الحكومة، ووسائل
الإعلام؟ والمشكلة أنه كلما اتسعت قاعدة الكذبة، وكلما أوغلت في القِدم كلما زاد
تصديقها، حتى تصبح بمثابة القاعدة التي لا يتسرب إليها الشك، والتي يحظر التساؤل
بشأنها. وما أكثر الكذبات الكبيرة في حياتنا.
وتصديق الخرافات ليس حكرا على المجتمعات المتخلفة؛ فمثلا،
ثلث الأمريكيين يؤمنون بالتنجيم، ويعتقدون أنه مبني على أسس علمية، وربما فاق عدد
المنجمين في أمريكا عدد العلماء بمئات الأضعاف.
من أراد أن يمتلئ قلبه باليقين، فلا بد أن يمتلئ أولاً بالشك.
والإيمان بالمسلّمات دون شك، هو أضعف أنواع الإيمان؛ لأنه إيمان عاطفي بلا عقل
وبدون دليل علمي يسنده، بل هو ضرب من التسليم والانقياد لشعارات وأيديولوجيات
معينة دون إرادة واعية، وهذا بحد ذاته عبودية، أو استغناء عن نعمة العقل والتفكير؛
وبالتالي استغناء عن ميزة الإنسان الأساسية.
من اعتاد التشكيك
في كل شيء، لن يصدق شيئا، ولن يدخل عقله أية أفكار جديدة. وما نحتاجه هو الشك بدون
هوس، والانفتاح بدون سذاجة، أي بجملة واحدة: استخدام العقل.
على أمل أن نفهم كُنْه الحياة، ونتوصل إلى سر السعادة، وكيف
لنا أن نخلّص الإنسان من عذاباته وشقائه الذي لازمه كظله طوال رحلته الطويلة...
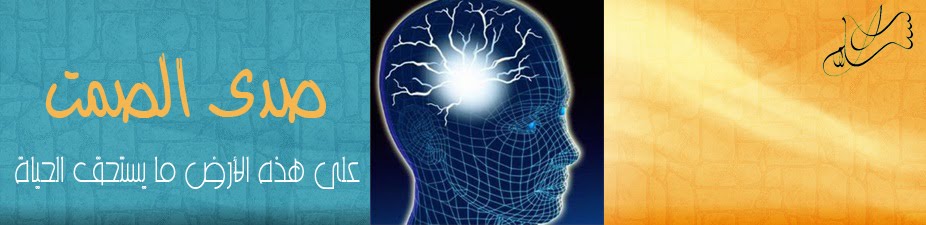
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق