مقدمة
لكل
فرد حقٌ طبيعي أن يعيش في بلدٍ تضمن له حقوق المواطَنة، وهذه أبسط حقوقه كإنسان، في
ظل شرعية دستورية وقانونية وسياسيـة حتى يستقر ويبدع، وخلاف ذلك، سيبقى في حالة قلق
وتوتر.. والمواطن العربي لا يعاني فقط من هذا القلق والتوتر، بل يعاني من سحق
كرامته، فهو يعيش في نظم استبدادية غير شرعية، أو في كنف شرعية لا يقتنع بها ولا ينتمي
إليها، سواء شرعية الأنظمة الحاكمة أم شرعية المعارضة. فالأنظمة التي استمدت
شرعيتها من الشعارات الثورية والتقدمية التي
رفعتها، ثم ابتعدت عنها شيئا فشيئا حتى انقلبت عليها، والأنظمة التي تتوارث السلطة
وليس لها دستور تحتكم إليه، والأنظمة التي تدعي الديمقراطية، وتقمع حرية التعبير
وتطبق الأحكام العرفية في الوقت ذاته، تعتبر جميعها أنظمة فقدت مشروعيتها.
لذا،
سيظل المواطن العربي يعاني من أزمة الشرعية، وهي أزمة إنسانية ومعنوية قبل أن تكون
سياسية وقانونية..
في
الحالة الفلسطينية الوضع مختلف، فالفلسطينيون لم يحصلوا على دولة بعد، وما زالوا
إما تحت الاحتلال المباشر، أو في بلدان المنافي، ومع ذلك، منذ أواسط الستينيات وهم
يعيشون في ظل نظام سياسي اسمه منظمة التحرير الفلسطينية، وهذه المنظمة تمثلهم
سياسيا، وتقود نضالهم السياسي والوطني منذ نشأتها، دون أن تكون لها سيادة على
الأرض، أو حكم مباشر على الشعب، ولكنها بعد أوسلو، صارت تحكم جزءا من الشعب في
المناطق التي تخضع لسيادتها باسم السلطة الوطنية.
وقد
اكتسبت المنظمة شرعية وجودها، وشرعية قيادتها للشعب، وشرعية تمثيله من خلال ما
يسمى بالشرعية الثورية، وقد انتزعت هذه الشرعية من خلال ممارستها الفعلية للكفاح
الوطني بكافة أشكاله، ولأنها كانت تتطابق مع تطلعات الشعب وأهدافه في التحرير ونيل
الحرية، والانعتاق من الاحتلال؛ أي لأنها كانت تمثل الحركة الوطنية الفلسطينية
بكافة أطيافها. وقد فرضت حركة فتح شرعية قيادتها للمنظمة، وللحركة
الوطنية الفلسطينية لأنها ظلت عماد الثورة الفلسطينية، وعمودها الفقري، ولم
تُفقدها شرعيتها بعض مواقفها المنفردة، أو تبوؤها للقيادة دون انتخابات شعبية
عامة، لأن الشعب كان في مرحلة تحرر وطني، ويخوض ثورة مسلحة، وظل هذا الوضع مقبولا حتى
إبرام اتفاق أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية عام 1994.
كان مثال ذلك ساطعا في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات،
الذي كرس شرعية قيادته لـ«فتح» ومنظمة التحرير والشعب الفلسطيني حتى في أصعب
المراحل وأكثرها إثارة للجدل.
هذه الحالة من
التعايش بين «الشرعية» و«عدم المشروعية» ليست حكرا على الحالة الفلسطينية، فهي
تظهر في العديد من النظم السياسية، وتمتد لتشمل الحركات والأحزاب السياسية أيضا.
وكان عالم الاجتماع الألماني "ماكس فيبر" قد فسّر الشرعية كظاهرة
اجتماعية، حيث حدد ثلاثة أنواع من الشرعية السياسية، هي: السلطة التقليدية
(القائمة على التاريخ والعادات)، والسلطة الكاريزمية (القائمة على شخصية القائد
وصدقيته)، والسلطة القانونية (المستندة إلى إطار من القواعد الرسمية القانونية).
وعموما، يتعامل علماء السياسة مع مفهوم الشرعية من منطلق علم الاجتماع كتعبير عن
إرادة الامتثال الشعبي لنظام الحكم. [1]
وبعد قيام السلطة الوطنية، لم تعد الشرعية الثورية مصدرا
وحيدا لشرعية القيادة والحكم، فقد تعززت هذه الشرعية من خلال انتخابات عامة جرت في
1996، وفاز فيها الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأفرزت أيضا مجلس تشريعي أغلبيته من
فتح. ثم تلتها انتخابات رئاسية ثانية جرت في 2005، وفاز فيها الرئيس محمود عباس،
وانتخابات تشريعية جرت في 2006. فازت فيها كتلة حماس بالأغلبية، التي مكنتها من
تشكيل حكومة. ثم في العام التالي حصل الانقسام.
ومن بعدها دخل النظام السياسي في أزمة الشرعية، والتي ما
زلنا نعاني منها حتى اليوم.
النظام
السياسي، ومفهوم الشرعية
النظام
السياسي عبارة عن مجموعة من الممارسات والسلوكيات المقنّنة، والتي تنظم عمل
المؤسسات والمجتمع بشكل قانوني، من خلال اللوائح القانونية الموثقة، والقواعد التي
تعمل الدولة على تطبيقها على الشعب الذي تحكمه، والمؤسسات الصانعة للقرار السياسي هي
المسؤولة عن تطبيق هذا النظام، وهي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
والنظام السياسي مفهوم أوسع من مجرد وصف شكل وآلية
ممارسة الحكم، الذي هو أحد مكونات النظام السياسي، فمفهوم النظام السياسي، يشمل
مؤسسات ولاعبين غير الحكومة والرئاسة، مثل الأحزاب السياسية، ومجموعات الضغط،
ومؤسسات المجتمع المدني، والمواطنين.. والنظام هو الذي يحدد علاقة هذه المجموعات ببعضها،
وآليات عملها، عبر القانون. [2]
ولا بد لأي
نظام سياسي أن يكتسب شرعيته، وإلا اعتبر نظاما استبداديا، أو فاشلا، وقبل أن
نتناول مصادر الشرعية، يتوجب تعريف مفهوم الشرعية.. وبحسب الموسوعة السياسية، مصطلح
"الشرعية" مفهوم سياسي مركزي مستمد من كلمة الشرع، أي القانون، أو العرف
المعتمد والراسخ، ويرمز إلى العلاقة القائمة بين السلطة والشعب، المتضمنة قبولا
طوعيا من قبل الشعب بقوانين وتشريعات النظام السياسي، بناء على توافق النهج
السياسي للنظام مع المصالح والقيم الاجتماعية للمواطنين، وهكذا تكون الشرعية علاقة
متبادلة بين الحاكم والمحكوم.
ومن هذا
المنطلق يتضح أن القبول والرضا هما أساس الشرعية، وبالتالي أي نظام سياسي بحاجة
إلى قبول شعبي ورضا جماهيري من الطبقات الاجتماعية كافة، وأحيانا يتعذر قياس مدى
الرضا الشعبي من قبل عامة الشعب، ولكن الأمور تكون أوضح عند الطبقات الأكثر فاعلية
وتأثيرًا. مع التأكيد
على أن وجود معارضة قوية للنظام لا تعني فقدانه الشرعية، بل قد يكون العكس، حيث تنبع
أهمية الشرعية من كونها القوة التي يستند عليها النظام في مقابلة خصومة من
المعارضة، حتى لو حاولت المعارضة نفي الشرعية عن النظام تمهيدًا لإسقاطه. ولكن
تعد كلّ من المظاهرات الشعبية الحاشدة، ودعوات الانفصال ومطالبات التقسيم
الفيدرالي أو الكونفدرالي مظهرًا من مظاهر زعزعة شرعية النظام الحاكم، وعلى
النقيض من ذلك يعد الاستقرار السياسي والاقتصادي دليلًا على تمتع النظام الحاكم
بالشرعية ووجود قبول ورضا شعبي بأداء السلطة.[3]
وبما أن مسألة القبول والرضا الشعبي أساسية في مفهوم الشرعية،
فقد طرحت ثلاثة اتجاهات لتحديد مصادر الشرعية:
الاتجاه القانوني: الذي يعرّف الشرعية بأنها سيادة
القانون، وخضوع السلطات العامة للقانون والدستور، وهو المفهوم المتبع في الدولة
الحديثة (الديمقراطية)، والذي تنظمه الانتخابات العامة، وهنا يمنح الشعب شرعية
النظام، وتكون السيادة للشعب.
الاتجاه الديني،
والأيديولوجي: والذي يعرف الشرعية على أنها تنفيذ أحكام الدين (القانون الإلهي)،
أو الأيديولوجيا الحزبية، وهنا تصبح القوانين والقرارات التي يصدرها النظام بمثابة
الحقيقة المنزلة والنهائية والمقدسة، وبالتالي لا حاجة للانتخابات، والتي تستبدل
بالتعيين والمبايعة، وهنا يمنح الدين (أو الأيديولوجيا) شرعية النظام، والذي سيكون
نظاما ثيوقراطيا.
الاتجاه الاجتماعي
السياسي: الذي يعرف الشرعية بأنها قبول غالبية المجتمع للنظام السياسي وخضوعهم له
طواعية، لاعتقادهم بأنه يسعى لتحقيق أهداف الجماعة، ويعبر عن قيمها وتوقعاتها.
ويمكن هنا إضافة مفهوم الشرعية الثورية، حيث يقبل الشعب بالنظام (أو الجماعة
الحاكمة) لاعتقادهم بأنه يمثلهم، وإيمانهم بأنه يسعى بهم نحو الحرية الاستقلال
وتحقيق أهدافهم الوطنية.
ومن الممكن
لأي نظام أن يزاوج في مصادر شرعيته، فقد يُجري انتخابات شكلية، أو يدعي تمثيل
العلاقة الحصرية بالدين، أو يزعم بأنه يناضل لتحقيق أهداف الشعب.. وعادة فإن هذا
النوع من الأنظمة ستعاني من فقدان شرعيتها، أو التشكيك بها. لأن الشرعية عملية
تطورية وليست مطلقة، وتوجد بدرجات متفاوتة قابلة للنمو أو التضاؤل، فكثير من النخب
الحاكمة قد تستولى على السلطة دون سند من مصادر الشرعية، ولكنها بمرور الوقت تكتسب
شرعيتها، وكذلك العكس نجد نظامًا حاكمًا يبدأ حكمه وهو مستند إلى شرعية واضحة
ولكنه بمرور الوقت قد يفقد هذه الشرعية.
وتبدأ أزمة
الشرعية بالظهور والتفاقم مع تصدعات النظام، أو مع تراجع أدائه، وتخليه عن
واجباته، وظهور قوى معارضة مقبولة جماهيريا، فأزمة الشرعية لا تتعلق فقط بالجانب
الأيديولوجي المبرر لوجود النظام، ولا بالجانب القانوني المتعلق بكيفية الوصول إلى
السلطة، بل بالعناصر البنيوية التي تقوم عليها الشرعية، وهي مدى توافق وتطابق ممارسات
النظام مع القانون والدستور، وبمدى اقتناع الشعب بحقيقة تمثيلهم، وتمثيل مصالحهم
في السلطة وقبولهم بذلك، ومقدار ونوعية الإنجازات وتحقيق تطلعات وتوقعات الشعب.
النظام السياسي الفلسطيني وأزمة الشرعية
بعد انطلاقة الثورة الفلسطينية، حظيت «فتح» ومنظمة
التحرير الفلسطينية بقبول فلسطيني عام بالشرعية التي مثلتها، وكثيرا ما أطلق عليها
وصف الشرعية الثورية، أو الشرعية التاريخية، أو شرعية البندقية، وشرعية القرار
الفلسطيني المستقل.. والتي استمدت شرعيتها من مصادر عدة تعتمد على ممارسة الكفاح،
والالتصاق بتطلعات الجماهير، والتعبير عنها، بطابع ثوري تحرري في سبيل الخلاص من
الاحتلال وعودة اللاجئين إلى الوطن، وممارسة حق تقرير المصير. وصولا إلى تعميم
القبول الشعبي بمنظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب، بل وانتزاع
إقرار عربي وعالمي، بما في ذلك من الأمم المتحدة، ولاحقا من إسرائيل نفسها، بهذه
الصفة التمثيلية للمنظمة. [4]
بمعنى أن المنظمة استمدت شرعيتها من الإرادة الشعبية
أولاً، التي ظلت تدين بالولاء للثورة وفصائلها طالما أنها تواصل رفع راية النضال وتقدم
التضحيات في سبيل تحقيق أهداف الشعب التي انطلقت لأجلها الثورة، وتستمدها أيضا على
المستوى الرسمي من اعتراف الدول العربية كافة بها، ومن ثم أغلبية دول العالم، والأمم
المتحدة بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
أي أن تلك الشرعية ما كانت لتتحقق لولا اعتمادها على
مصدرها الأساس، وهي الإرادة الشعبية، التي دانت بالولاء للمنظمة كقائدة لحركة
التحرر الوطني الفلسطيني، وطليعتها «فتح» قائدة الثورة، وتجلى ذلك أيضا عبر
الانتخابات التي كانت تجري داخل المجلس الوطني لانتخاب اللجنة التنفيذية ورئيسها
(اتسمت بالمحاصصة)، وعبر تمثيل في الاتحادات النقابية والقطاعية ذات الحصة في
مؤسسات المنظمة، ولو عبر انتخابات شكلانية.
ولم تؤثر قوى المعارضة الجذرية للمنظمة على شرعيتها
الوطنية، وشرعية تمثيلها للشعب (أي القوى الرافضة لها، والتي لم تعترف بها)، فأي
نظام سياسي في العالم لا بد من وجود قوى مناوئة له، أو مشككة بشرعيته، ومن المتعذر
أن يحظى أي نظام بإجماع كامل من قبل الشعب..
وبعد قيام
السلطة الوطنية، صار النظام السياسي الفلسطيني قائما على كيانين، يتمايزان
هيكلياً، إنما مع بعض التداخل القائم، خاصة على مستوى رأس الهرم، الكيان الأول
تمثله منظمة التحرير، وهي الأرفع مكانة، بفعل مركزها القانوني، وصفتها التمثيلية،
وعمقها التاريخي الذي أكسبها رمزيتها الوطنية، والمعنوية الإعتبارية؛ وبالتالي
الشرعية الشعبية. الكيان الثاني تجسده السلطة الوطنية، والتي استمدت شرعيتها من
المنظمة أولا، ثم من الانتخابات العامة، وقد باتت مركز السلطة الفعلي سياسيا
وتنظيميا، بمقياس الدور والصلاحيات والفعالية المؤسسية، التي أدت مجتمعة إلى
انتقال مقاليد العملية الوطنية بالممارسة إليها.
ومع ذلك، لم
تظهر معالم أي أزمة شرعية للنظام السياسي الفلسطيني، سواء لقيادة المنظمة، أم
لقيادة السلطة، حتى العام 2006، أي بعد الانتخابات التشريعية التي فازت فيها حماس
بالأكثرية. وحتى نكون أكثر دقة، بدأت أزمة النظام السياسي الفلسطيني بالظهور،
عندما انتفى التوازن في العلاقة ما بين المنظمة والسلطة، حيث لجأ القيّمون على
مركز القرار الرسمي، وبالتالي على السلطة، إلى إضعاف وتهميش منظمة التحرير، وصولاً
إلى تصفية العديد من مؤسساتها، مدفوعين بالأمل بأن السلطة الوطنية هي الدولة في
صيرورتها، ما عنى أن مركز القرار الرسمي تخلَّى بوعي عن أحد أهم عناصر القوة
الفلسطينية الذي تجسده م.ت.ف بمكانتها، ومؤسساتها، وطاقتها التعبوية المتميّزة،
إنطلاقاً من التفاف الشعب حولها. ثم إزدادت منظمة التحرير ضعفاً، وتآكلت
مكانتها سياسياً، ولكن دون أن تفقد شرعيتها القانونية والتمثيلية الرسمية. [5]
أحد أسباب ضعف
المنظمة، عدم استيعابها حركتي حماس والجهاد في أطرها، على الرغم من أهمية الدور
الوطني والنفوذ الجماهيري لهذين التنظيمين، ما أسس لاحقا لصراع على السلطة سيقود
إلى الانقسام.
وفي الواقع،
ظلت حماس (وفوى أخرى) تشكك وتطعن في شرعية المنظمة، دون أن تطرح نفسها بديلا عنها،
ربما طرحت نفسها كجسم موازي للحركة الوطنية أثناء الانتفاضة الأولى، ولكنها في
الانتفاضة الثانية، وبسبب تغير موازين القوى الداخلية، ونتيجة ظروف إقليمية معينة
بدأت تستشعر قوتها، وتطرح نفسها بديلا عن المنظمة، وتدعي شرعية تمثيلها للشعب
الفلسطيني، حتى قبل فوزها في الانتخابات.
الأسباب الخلفية المتوارية للأزمة
منذ نشوء النظام السياسي الفلسطيني وتطوره ضمن مختلف المراحل التاريخية لم
يكن القرار السياسي قرارًا فلسطينيًّا مستقلًّا بالمعنى الكامل، فقد كانت المنظمة
تفتقد للأرض وبالتالي لم يكن لها حكما مباشرا على الشعب، كما أن ظروف المنفى ودكتاتورية
الجغرافيا السياسية فرضت عليها اشتراطات معينة، لذا ظل النظام السياسي الفلسطيني
مرهونًا ومتأثرا بظروف دولية وإقليمية متغيرة، الأمر الذي جعله أكثر عرضة للتغيرات
الداخلية، بل إن هذا التداخل والتأثير الإقليمي والدولي أوجد وعمّق أزمة النظام.
ومن ناحية ثانية، فإن النظام السياسي الفلسطيني بعد تأسيس السلطة لم تعد
تنطبق عليه المعايير التقليدية؛ سواء تلك المتعلقة بالنظام الرئاسي أو النظام
البرلماني، فشكل النظام السياسي الفلسطيني له سماته وخصوصيته المنفردة، والتي ربما
فاقمت من الأزمة.
بدأت أزمة
النظام السياسي الفلسطيني تتضح أكثر بسبب فشل القيادة الفلسطينية في كسر قيود
الإتفاق السياسي الذي أنجب السلطة الوطنية، أي إتفاق أوسلو، الذي ما انفك يحاصرها
خلف جدران الحكم الإداري الذاتي على السكان في الضفة والقطاع، فواصل الإحتلال
استيطانه المنهجي للأرض، وفرض على السلطة الوطنية التزامات إقتصادية، إدارية،
وأمنية بخاصة، لم تتمكن حتى الآن التحرر من إملاءاتها. [6]
ثم تفاقمت
أزمة النظام السياسي، خاصة، بعد أن فشلت عملية التسوية السياسية، فبعد انهيار
مفاوضات كامب ديڤيد في تموز 2000 ، لم تنطلق أي عملية سياسية جدية، وتوقفت
المفاوضات، وأغلق الأفق السياسي، واندلعت الانتفاضة الثانية.
ومع تطور الأحداث أثناء الانتفاضة وبعدها سيظهر لاحقا، أنه
لم يكن من أولويات القيادة السياسية الفلسطينية وضع قواعد دستورية صارمة، ولم تكن
هناك رؤية واضحة حول طبيعة النظام السياسي المطلوب للحالة الفلسطينية الثورية أو
للسلطة الوطنية، وإنما تم وضع النظام وتصميمه، وتعديله لاحقًا، تحت إلحاح وضغوطات
ظروف سياسية وقتية، ومن خلال مواءمات ومفاوضات بين الأطراف الفاعلة في النظام
السياسي. [7]
ونتيجة غياب الرؤية المشتركة والموحدة بين شتى الأطراف،
وربما بسبب ضعف الثقة بينها أيضا، والتدخلات الإقليمية.. لم تنجح جلسات الحوار
العديدة والمطولة بين مختلف الفصائل والمؤسسات الوطنية في إدخال تعديلات جوهرية
على النظام السياسي، بحيث تبدد الغموض، وتضع ضوابط صارمة، فظهر بعض التشويه وعدم
الاتساق وعدم وضوح حدود المهام والصلاحيات بين السلطات.
بدايات الأزمة
وتطوراتها
منذ تأسيس السلطة ظل النظام السياسي الفلسطيني يعمل وفق
أسس النظام الرئاسي، وفي عام 2003، ونتيجة ضغوط سياسية خارجية، كان الهدف منها
إقصاء عرفات، وتقليص صلاحياته، وإنهائه سياسيا، تم استحداث منصب رئيس الوزراء،
والذي أسند حينها للرئيس محمود عباس، ليتحول إلى نظام مختلط «شبه رئاسي»، وقد شهدت
الفترة ما بين تقلد أبو مازن منصبه إلى استشهاد ياسر عرفات صراعًا على الصلاحيات
بينهما، حيث لم تكن بنية النظام السياسي الفلسطيني مهيأة لهذا التغيير البنيوي.
وبعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في كانون الثاني 2005،
وفاز فيها الرئيس محمود عباس أصبح رئيس السلطة الوطنية، وهو نفسه رئيس منظمة
التّحرير الفلسطينية، ورئيس حركة فتح كذلك، حتى بات من الصعب تحديد الخط الفاصل
بين المنظمة والسلطة. [8]
ثم انتقل النظام السياسي الفلسطيني لمرحلة مهمة في عام
2006 بعد الانتخابات التي فازت فيها كتلة حماس بالأغلبية ومن ثم تشكيل الحكومة
العاشرة برئاسة إسماعيل هنية، ليتشكل نظام سياسي برأسين، يسيطر عليه برنامجان
مختلفان، أحدهما في رئاسة السلطة والآخر في رئاسة الوزراء. وكان من الطبيعي أن
يؤسس ذلك لتعارض في السياسات في ظل غياب الجاهزية للتداول السلمي للسلطة وغياب
مفهوم الشراكة، مما تسبب في انقسام سياسي وتعطيل دور المجلس التشريعي لصالح مؤسسة
الرئاسة، ودخول النظام السياسي في إشكالية دستورية قانونية إلى يومنا هذا. [9]
كان لفوز حماس في الانتخابات وتشكيلها
حكومة "حمساوية" تأثيرات سلبية في واقع حياة الشعب الفلسطيني،
فقد فُرض حصار مالي وسياسي خانق على السلطة الوطنية في الضفة والقطاع على حد سواء،
بسبب رفض حكومة حماس التعاطي مع الشرعية الدولية، ورفضها الاعتراف بالإتفاقيات
التي وقعتها السلطة سابقا، ورفضها الاعتراف بإسرائيل، هذا الحصار جعل الأوضاع
الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني تتراجع خطوات للوراء.
ثم تفاقمت الخلافات الداخلية بين
الأشقاء حتى وصلت مرحلة الإقتتال الداخلي وسفك الدم الفلسطيني بأيدي فلسطينية، حتى
وصل الخلاف ذروته بإنقلاب حماس على السلطة الشرعية وانفصال غزة عن الضفة في حزيران
2007. وعلى إثر ذلك قام الرئيس محمود عباس بإقالة الحكومة واعتبارها غير شرعية،
وأسندت رئاسة الحكومة (في الضفة الغربية) إلى الدكتور سلام فياض.
وهكذا، بعد أن كان النظام السياسي الفلسطيني يعاني من أزمة وجود سلطة
برأسين (الرئاسة والحكومة)، بعد الانقلاب الحمساوي (أو الحسم العسكري كما أسمته) أصبح
النظام يعاني من أزمة الانقسام ووجود سلطتين. ومن ناحية ثانية فإن هذا التحول
أوصلَ الحركة الإسلامية إلى مربع الحُكم، وهو المربع الذي وضعها بين مطرقة القيود
الدولية واشتراطاتها، وسندان الحصار. وأدخل هذا الانتقال غزة بأكملها عهدا جديدا
ومختلفاً.
في تلك
المرحلة ادعى كل طرف أنه يمثل الشرعية الفلسطينية؛ حكومة حماس قالت أنها جاءت بقوة
الانتخابات، أي أنها صارت تستمد شرعيتها من صندوق الانتخابات، وبالتالي فإن المجلس
التشريعي (الذي تسيطر عليه حماس) هو الشرعية، بينما قالت السلطة في الضفة أنها
تمثل الشرعية، لأن النظام السياسي والقانون الأساسي يعطيان الصلاحيات الكاملة
للرئاسة، ولأن السلطة تستمد شرعيتها القانونية من منظمة التحرير، وشرعيتها الرسمية
من اعتراف العالم بها. مضيفة بأن الانتخابات لوحدها لا تعطي تفويضا مطلقا وأبديا
لمن فاز فيها.
وحسب القانون
العام، فإن مدة صلاحية المجلس التشريعي أربع سنوات، وكذلك مدة الرئاسة.. هذا الأمر
أوجد أزمة جديدة بعد انقضاء السنوات الأربع، فبمجرد انتهاء مدة ولاية الرئيس
(كانون ثاني 2009) صار الخطاب الحمساوي يركز على أن الرئيس انتهت ولايته، وبالتالي
فقد الشرعية.. ولكن، بعد سنة انتهت ولاية المجلس التشريعي أيضا، وبالتالي وبنفس
المنطق والحجة القانونية لم يعد المجلس شرعيا، ولكن نواب حماس قالوا أن المجلس يظل
شرعيا حتى تنظم انتخابات تشريعية ثانية تأتي بمجلس جديد.. والمشكلة أنه لم تجر من
بعدها أية انتخابات رئاسية، أو تشريعية.
في نيسان 2014 ، تم الاتفاق
بين فتح وحماس على تشكيل حكومة توافق فلسطينية، على أن يعقبها بستة أشهر
إجراء انتخابات عامة؛ وأكد الطرفان على الالتزام بما تم التوصل إليه في
"اتفاق القاهرة 2011" و"اتفاق الدوحة 2012″، واعتبارهما
المرجعية في تنفيذ المصالحة الوطنية. لكن هذا الاتفاق لم يكن كفيلا بإنهاء
الانقسام، حيث إن حكومة التوافق لم تستلم مهامها بشكل كامل في قطاع غزة بالرغم من
وجود أربعة وزراء مستقلين من القطاع.
وعلى إثر ذلك
قررت قيادة حماس حل الحكومة في غزة، وتحويلها إلى "لجنة إدارية"، تتولى
حكم القطاع، إلى حين قدوم حكومة التوافق الوطني إلى غزة، واستلام السلطة. وفي أيلول
2017، قررت حماس حلّ اللجنة الإدارية في غزة، وأعلنت عن استعدادها للتخلي عن
السلطة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تشارك فيها الفصائل الفلسطينية كافة، وفق الاتفاقيات
السابقة وإجراء انتخابات عامة، مقابل رفع الحصار عن غزة والحصول على دعم مالي
إقليمي، يخفف من ظروف الحصار الصعبة وتداعياته.
من جهتها، اتهمت حماس حكومة التوافق الوطني بعدم القيام بمسؤولياتها، بينما
اعتبرت حكومة التوافق أن تشكيل حركة حماس لما أسمته "لجنة إدارة شؤون قطاع
غزة" قرارا مخالفًا لبنود اتفاق الشاطئ الذي تشكّلت الحكومة بموجبه، وأضافت بأن
حركة حماس منعت وزراء الحكومة من مغادرة الفندق الذي نزلوا فيه، ومنعتهم من مقابلة
كبار الموظفين في وزاراتهم، وبالتالي شلت حركتهم. ثم وقعت حادثة محاولة اغتيال
رئيس الحكومة "رامي الحمد الله" في غزة.. ما أعطى انطباعا بأن حماس لم
تكن جادة في مسألة تخليها عن السلطة.
وفي كانون أول
2018، أعلن الرئيس عباس عن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، وفي المقابل، رفضت حركة حماس
القرار معتبرة أنه "ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية ولا يعدو كونه قراراً
سياسياً". مؤكدة بأن "المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية
باطلة في تشكيلها". ومع ذلك ما زالت كتلة حماس البرلمانية تعقد اجتماعاتها في
مقر المجلس التشريعي في غزة، وتعتبر نفسها تمثل الشرعية، وما زالت المحاكم في غزة
تعمل بشكل مستقل ومنفصل تماما عن السلطة في رام الله. وما زال الانقسام قائما،
ويتعمق ويترسخ يوما بعد يوم.
معالم وتجليات الأزمة
بعد انتهاء
ولاية كل من الرئيس والمجلس التشريعي، وعدم القدرة أو الرغبة في إجراء انتخابات
جديدة، واستمرار الانقسام بين سلطتين في الضفة والقطاع، واتضاح مأزق عدم قدرة
السلطة على العبور إلى الدولة المستقلة..كانت النتيجة الكارثية محاولات فرض القبول
بشرعية كل من السلطة في الضفة الغربية، والسلطة في قطاع غزة، ومشروعية ما تنفذانه
من سياسات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. [10]
وبعد فشل كل محاولات، ووساطات، ومبادرات، إنهاء الإنقسام
الداخلي الذي تكرس منذ عام 2007، بوجود سلطتين متنافستين تحت الإحتلال، على أرضية تناقض
سياسي وخلافات برامجية في الساحة السياسية. تكون أزمة الشرعية في النظام السياسي الفلسطيني قد وصلت حدا
خطيرا.
والأزمة لا تتجلى فقط في تكريس واقع الانقسام، بل وأيضا
في التراجع الخطير والمتواصل للديمقراطية الداخلية، والمس بالحريات العامة، والحق
في حرية الرأي، وعودة ظواهر الإعتقال السياسي، والاعتداء على المتظاهرين. والفشل في
بلورة آلية للشراكة الديمقراطية كضرورة أساسية للتعددية السياسية في الساحة
الفلسطينية، سواء على مستوى قيادة النضال الوطني، أو إدارة العمليات السياسية، أو
إدارة السلطة، أو إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية لتكون البيت الجامع والممثل لكل
المكونات الفلسطينية. هذا إضافة إلى تعمق أنماط التعصب الحزبي والفئوي، وتدهور الأوضاع
الاقتصادية للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، والغضب الشعبي على غياب العدالة
الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وسيادة القانون، وانتشار مظاهر المحسوبية والواسطة..الخ. وهذه أزمة
عميقة، لم يعد ممكنا إنكارها أو التستر عليها. [11]
وفي السياق ذاته، يمكن
القول أن أزمة حماس ربما أعمق وأخطر، خاصة بعد نحو 15 سنة من حكمها المنفرد
للقطاع، وما آلت إليه الأمور من تدهور للأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية،
وبسبب الحصار، وإغلاق المعابر الحدودية، وتفاقم الفقر والبطالة، فضلا عن أربعة
حروب عدوانية شنها جيش الاحتلال على القطاع، وتسببت بخسائر جسيمة في الأرواح
والممتلكات.. إلى جانب أزمة حماس المتمثلة في عجزها عن الموائمة بين شعارات
المقاومة (مبرر وجودها كحركة مقاومة)، وبين ضرورات ومتطلبات البناء والحياة اليومية
للمواطنين (مبرر حكمها للقطاع)، وعدم اعتراف العالم بشرعية حكمها، وما تتعرض له من
عقوبات، وتجفيف لمواردها المالية، وخسارة حلفائها في الإقليم واحدا تلو الآخر،
الأمر الذي أجبرها على قبول المنحة القطرية عبر إسرائيل مباشرة، وبموافقة أجهزتها
الأمنية، ما وضعها في موقف حرج ودقيق.
أمام هذه
الأزمة سعت القيادة الفلسطينية للخروج منها، وتمثل ذلك في محطات عدة؛ فمثلا في
مواجهة صفقة القرن، وللتصدي للضغوطات الخارجية أعلنت القيادة موقفها الصريح والقوي
في رفض التعاطي مع صفقة القرن، بل وحتى التعاطي مع الإدارة الأمريكية (في عهد
ترامب)، ثم أتى الرد الفلسطيني على سياسات الضم والاستيطان، بقرار المجلس المركزي،
وقرارات المجلس الوطني في دورته ال 23– 2018، بأن السلطة والمنظمة باتت بحلٍ من
الإتفاقيات والتفاهمات التي وقعت مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، ومن كافة
الإلتزامات المترتبة عليها، بما فيه الجانب الأمني، والإعلان عن وقف كافة أشكال
التنسيق الأمني. (تم التراجع عن القرار فيما بعد).
وتكمن أهمية
هذه القرارات أنها شكلت نقطة إنعطاف في السياسة الفلسطينية، وأنها طُرحت للتنفيذ،
ما أشاع جواً من الترحيب الوطني العام، فتحَ ملف البحث الجاد في كيفية تجاوز
الإنقسام، باعتبار أن التقاء مساعي الخروج من أوسلو، مع ما يقابلها من جهد لإعادة
بناء الوحدة الداخلية، إنما يرسمان معاً طريق تجاوز النظام السياسي لأزمته. [12]
تمثلت المحاولة
الثانية في مُخرجات إجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد في لبنان،
أيلول 2020، التي اعتمدت آلية تقوم على ركيزتين لاستنهاض الحالة الوطنية ومواجهة
مشروع الضم، هما: تشكيل لجنة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، وإعتماد
رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الإنقسام، وإجراء المصالحة، وإحداث الشراكة في إطار منظمة
التحرير. [13]
لكن سرعان ما
تم التخلي عن هذه الآلية التي حظيت بالإجماع الوطني، لصالح آلية أخرى، تم التوصل
إليها بين حركتي حماس وفتح في لقاء جمعهما في إسطنبول في أواخر نفس الشهر (أيلول
2020)، آلية تقوم على الدعوة لانتخابات عامة متتالية ومترابطة: تشريعية، رئاسية،
ومجلس وطني. أعقبها صدور
المراسيم الرئاسية بالدعوة للانتخابات بمحطاتها الثلاث المتعاقبة:
الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية يوم 31/7/2021، على أن تعتبر
نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني،
ثم تستكمل انتخابات المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير
الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.
ولكن قبل حلول
موعد الانتخابات، قررت الرئاسة تأجيلها إلى أجل غير مسمى، تحت ذريعة رفض إسرائيل
إجراء الانتخابات في القدس، واعتبار القيادة موضوع القدس خط أحمر، وأنها أهم من
الانتخابات.
وهكذا، بعد أن
مثلت الانتخابات مخرجا ممتازا للخروج من الأزمة، أو حلحلتها على الأقل، جاء قرار
إلغاء الانتخابات ليزيد من عمق الأزمة، ومن خطورتها. ما يؤكد مرة أخرى على دور
إسرائيل المحوري في إيجاد وتعميق الأزمة الفلسطينية.
غير أنه ما كان لأزمة الشرعية وأزمات السلطة أن تستفحل
إلى هذا الحد لو لم تقابلها أزمة فى شرعية القوى المعارضة لها، فهذه القوى ذاتها
تحاول أن تستمد شرعيتها من شعارات وبرامج تواصل ادعاء تمثيلها لمصالح الشعب، من
دون أن تحصل على تفويض شعبي يعزز هذا الادعاء، لا عبر صناديق الاقتراع، ولا عبر
إعادة الاعتبار لشرعية المقاومة ضد الاحتلال، ولا بالتمرد على شرعية فقدتها السلطة
القائمة في كل من الضفة والقطاع، وقبل ذلك من دون تجديد ديموقراطي في بناها
التنظيمية يكسر معادلة تأبيد القيادة وعجزها عن تطوير برنامج حركة التحرر الوطني
الفلسطيني ووسائل وأدوات كفاحها الجمعي ضد الاحتلال والعنصرية. [14]
تصورات للخروج
من الأزمة
مع تفاقم أزمة
الشرعية لم يعد النظام السياسي الفلسطيني يمتلك ترف المفاضلة بين استراتيجية
وأخرى، فالخيار الوحيد المتاح أمامه، ولا خيار سواه، هو تغليب غريزة البقاء على نزعة
الإنتحار، وبالتالي ليس أمامه سوى الخروج من أزمته، والإقدام على خطوات عملية
واتخاذ قرارات تاريخية تجعله يضع قدميه على بداية السكة، وهذا يتطلب بداية تجاوز
حال الإحتكار البيروقراطي للسلطة، والتفكير بعقلية منفتحة، وبروح مسؤولة، ترى
المستقبل وتهتم به قبل اهتمامها بالحاضر.
وهذه الأزمة
من شقين، الأول: وجود سلطتين، متعارضتين، ببرنامجين متناقضين، وقد أدى ذلك إلى
الانقسام السياسي والجغرافي، ما أضعف من الصفة التمثيلية لمنظمة التحرير، وللقيادة
الفلسطينية الرسمية، وبالتالي إضعاف الموقف الفلسطيني كله. والثاني: انسداد الأفق
السياسي، وتعثر التسوية، مع استمرار سياسات التهويد والضم والاستيطان، وعجز كلا
السلطتين عن إحداث أي اختراق سياسي، أو تحقيق منجزات جوهرية، فضلا عن تراجع الروح
النضالية، وتراجع سقف الحريات، واستفحال بعض مظاهر الفساد (ربما الوضع أفضل نسبيا
في الضفة الغربية، على الأقل من الناحية المعيشية) لكن الاحتلال لا يوفر فرصة
لتقويض أي منجز، ووضع العراقيل أمام أي حالة تقدم، بل إنه يتعمد إلى إضعاف
"السلطتين"، وترسيخ حالة الانقسام.
إذن، الخطوة
الأولى للخروج من الأزمة، تتمثل في إنهاء الانقسام، وهذا شرط تأسيسي، ومن ثم ترسيخ
الوحدة الوطنية، والبدء فورا في إصلاح منظمة التحرير، وإعادة بناء مؤسساتها
بوظائفها التعبوية الشاملة لطاقات فلسطينيي الشتات، وصياغة إطار نظام سياسي موحد،
بروح ثورية جديدة، وببرنامج سياسي مقاوم. وهذا يعني توقف محاولات التعايش مع
الانقسام، وجعله انقسام توافقي، كما يحدث الآن عبر جولات الحوار والمصالحة التي لم
تفضِ إلى شيء، لأنها تحولت إلى عملية مصالحة تدير الانقسام بدلا من أن تنهيه. هذا
ما يتعلق بالشق الأول.
ما يتعلق
بالشق الثاني، يتوجب اعتماد خيار المقاومة الشعبية، والعمل على تصعيدها وتعميمها،
وتبني استراتيجية دفاعية هدفها تثبيت ودعم صمود الشعب فوق أرضه، ورفض أي مناورة
سياسية تصفوية. وعلى الصعيد الداخلي: إطلاق حرية الرأي والتعبير، وتحريم كل أشكال
الاعتقال والقمع والاستدعاءات السياسية، واتخاذ إجراءات جدية بشأن ملف الفساد،
وتمتين الجبهة الداخلية، بخطاب إعلامي وطني موحد.. وهذا يعطي مشروعية للنظام،
ويزيد من التفاف الشعب من حوله، ويجعله متفهما لعجز النظام عن اختراق حالة
الانسداد السياسي.
وفي التفاصيل،
هناك الكثير مما يتوجب فعله: تعميق الشراكة الوطنية، وتوسيع حيِّزها، وانفتاح المؤسسات
على المشاركة، ولكن دون محاصصة، والإعلان الفوري عن إجراء إنتخابات تشريعية، ورئاسية،
وللمجلس الوطني، دون إنتظار موافقة الاحتلال على إجرائها في القدس، بل جعل
الانتخابات فيها معركة مقاومة شعبية.
والبدء بهجوم
سياسي يستهدف الساحة الدولية، من أبرز عناوينه: مواصلة الجهود الدبلوماسية لجهة
توسيع الإعتراف بالحقوق الوطنية، واعتراف المزيد من دول العالم بالدولة
الفلسطينية، تطوير حملة المقاطعة، ودعم جهود حركة الBDS ، وتعزيز حملة مقاضاة إسرائيل
وملاحقتها في المحاكم الدولية، ضمن مفهوم تطبيق مباديء القانون الدولي للمحاسبة
على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ومواصلتها سياسة الإستيطان، وتصعيد حملة معاملة
إسرائيل كنظام أبارتهايد، وفتح ملف التضامن من أجل الإفراج عن الأسرى، وإنهاء الحصار
على القطاع.
وأخيرا، التفكير بشكل إيجابي في قضية تغيير الدور الوظيفي للسلطة،
بحصرها في تسيير الأمور الحياتية، وإعادة مركز الثقل السياسي إلى منظمة التحرير
الفلسطينية.
خلاصة
تبين لنا من خلال ما تقدم أن العنوان الأبرز
لأزمة الشرعية هو وجود سلطتين، الأولى في الضفة الغربية وتقودها فتح، والثانية في
غزة وتقودها حماس، وبالتالي صار ضروريا تحديد مستويين رئيسين نشخص فيهما نقاط
الخلاف والإلتقاء بين الحركتين: المستوى الإستراتيجي العام، ونجد فيه تباين طفيف
وأحيانا تطابق شبه تام في رؤية الحركتين وموقفهما من القضايا الكبرى كالتسوية
السياسية، ومشروع الدولة الفلسطينية، وفلسفتهما من المقاومة وممارستهما لها،
والمفاوضات المباشرة، وكذلك موقفهما الملتبس من الإعتراف بإسرائيل. وفي المستوى
الثاني سنجد قضايا وعوامل سياسية وميدانية ذات بعد تكتيكي، ولكنها مهمة ومؤثرة،
ومنها تأثير العامل الخارجي، وبناء الثقة بين الطرفين والمرجعيات المؤسسية، إلى
جانب القضايا التفصيلية الشائكة والتي نجمت عن الإنفصال أو كانت سببا له..[15]
وقد نتفق في النهاية أن كل ما تقدم
عبارة عن الشكل الظاهري لتناقض الحركتين، وأن جوهره عبارة عن تناقض بين مشروعين:
المشروع الوطني القومي في مواجهة المشروع العالمي للإسلام السياسي، ولن نتطرق هنا للحكم
على المشروعين، ومدى أهمية كل منهما لفلسطين، ولقضية فلسطين، في هذه المرحلة
تحديدا.
وطالما أن الهدف
السياسي المعلن لكل من فتح وحماس يكاد يكون متطابقا، فهل ما يجري من خلاف واقتتال
بين التنظيمين هو نوع من الصراع على السلطة؟! وصراع على من سيفاوض إسرائيل ومن
سيوقع معها الحل النهائي؟! أم صراع على الكراسي والموارد والثروة ومناطق النفوذ
كما يجري في الكثير من بلدان العالم؟! وطالما أن السلطة التي يجري الصراع عليها هي
سلطة تحت الاحتلال وبلا صلاحيات ولا تمتلك موارد ولا ثروات حقيقية، فهل هؤلاء
المتصارعين مجانين وعميان؟! الحقيقة أنهم ليسوا كذلك بالمطلق، ولكن الموضوع له
علاقة بما هو بعد السلطة وبما هو أبعد من البرنامج السياسي.
وصار واضحا لدينا من خلال ما تقدم بأن صراع فتح
وحماس هو صراع بين مشروعين مختلفين، المشروع الوطني الذي تمثله فتح ومعها فصائل
منظمة التحرير ذو الطبيعة الوطنية والساعي لبناء دولة فلسطينية ومجتمع مدني،
ومشروع الإسلام السياسي الذي تمثله حركة حماس وحلفائها ذو الطبيعة الدينية والساعي
لبناء دولة إسـلامية وفرض القضايا الأممية
الكبرى ( المشروع الإسلاموي العالمي ) على حساب المشروع الوطني.
قد يرى البعض أن انتصار أحد المشروعين يعني خسارة
الآخر، وهذه حقيقة نسبية، ولكن السؤال الذي يبرز فورا هو انتصار من على من؟ انتصار
فتح على حماس أو العكس؟ أم انتصار أحد الطرفين على إسرائيل؟ والفرق كبير جدا بين
الحالتين، فقد يتمكن فصيل من إلحاق هزيمة عسكرية بالآخر كما فعلت حماس في غزة في
صيف 2007، ولكن هذا لم ولن ينهي الصراع لا بين الفصيلين الشقيقين ولا مع الاحتلال،
بل هو حتما يؤخر أو يعطل بل ويمنع انتصار أي من الطرفين على الاحتلال، لأنه من
البديهي أن الانتصار على الاحتلال يتطلب أولا وقبل أي شيء آخر توحد الفصيلين على
أرض المعركة في مواجهة الاحتلال، وتوظيف كل إمكاناتهما التنظيمية والعسكرية
والجماهيرية والسياسية ضمن استراتيجية موحدة تذوب فيها كافة التناقضات الفرعية
والهامشية. وغير ذلك ستظل أزمة الشرعية قائمة، ومستفحلة.
الهوامش
[1] خليل شاهين، "فتح" والبحث عن تجديد الشرعية،
المركز الفلسطيني لأبحاث السياسيات والدراسات الإستراتيجية- مسارات، رام الله،
8-5-2016.
[2] محمد الأغا، النظام
السياسي الفلسطيني.. المسارات والأزمات البنيوية، ساس بوست، 28-2-2022، https://www.sasapost.com/opinion/plestenian-political-system-structural-cisis/
[3] منار ممدوح، مفهوم الشرعية، الموسوعة السياسية، https://political-encyclopedia.org/dictionary/
[4] خليل شاهين، "فتح"، مصدر سبق ذكره.
[5] فهد سليمان، النظام السياسي الفلسطيني عند مفترق طرق،
12-4-2021، وكالة معا الإخبارية، https://www.maannews.net/articles/2037315.html
[6] فهد سليمان، النظام السياسي، مصدر سبق ذكره.
[7] محمد
الأغا، النظام السياسي الفلسطيني، مصدر سبق ذكره.
[8] محمد
الأغا، النظام السياسي الفلسطيني، مصدر سبق ذكره.
[9] محمد
الأغا، النظام السياسي الفلسطيني، مصدر سبق ذكره.
[10] خليل شاهين، "فتح"، مصدر سبق ذكره.
[11] د. مصطفى
البرغوثي، أزمة النظام السياسي الفلسطيني والمطلوب لحلهـا، وكالة معا الإخبارية،
4-8-2021، https://www.maannews.net/articles/2046590.html
[12] فهد سليمان، النظام السياسي، مصدر سبق ذكره.
[13] فهد سليمان، النظام السياسي، مصدر سبق ذكره.
[14] خليل شاهين، "فتح"، مصدر سبق ذكره.
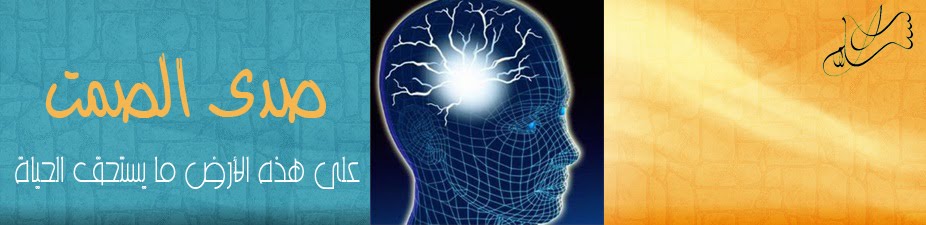
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق